عالم ما بعد فيروس الكورونا للكاتب يوفال نوح حراري يوضح فيه يوفال نوح حراري ماهية عالم ما بعد فيروس الكورونا مستعرضا تخوفاته وما نحتاجه لتشكيل عالم أفضل بدلًا من عالم منعزل شديد الرقابة يقتص من حرياتنا، فيقول:
“إن مطالبة الناس بالاختيار بين الخصوصية والصحة هو في الواقع أصل المشكلة، لأنه خيار زائف. يمكننا -وينبغي أن- نتمتع بالخصوصية والصحة معًا. يمكننا أن نختار حماية صحتنا ووقف وباء الفيروس التاجي؛ ليس عن طريق إنشاء أنظمة مراقبة استبدادية، ولكن عن طريق تمكين المواطنين.”
يوفال نوح حراري
إليكم المقال:
تواجه البشرية الآن أزمة عالمية، ربما كانت أكبر أزمة في جيلنا، ويُحتمل أن تشكّل القرارات المُتخذة خلال الأسابيع القليلة المقبلة من الشعوب والحكومات عالمنا لسنوات قادمة. لن ينحصر تأثيرها على أنظمة الرعاية الصحية فقط ولكن ستشكّل اقتصادنا وسياستنا وثقافتنا. يجب علينا أن نتصرف بسرعة وحسم، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار العواقب طويلة المدى لأعمالنا. عند الاختيار بين البدائل، يجب أن نسأل أنفسنا ليس فقط عن كيفية التغلب على التهديد المباشر، ولكن أيضًا عن نوع العالم الذي سنعيش فيه بمجرد مرور العاصفة. نعم، ستمر العاصفة، وستبقى البشرية على قيد الحياة، سيظل معظمنا على قيد الحياة – لكننا سنعيش في عالم مختلف.
ستصبح العديد من تدابير واجراءات الطوارئ قصيرة الأجل من عناصر الحياة الأساسية في المستقبل. هذه هي طبيعة حالات الطوارئ، فهي تسرّع من العمليات التاريخية والقرارات التي قد تستغرق في الأوقات العادية سنوات من المداولات، ولكن تُمرر في حالات الطوارئ في غضون ساعات. يُدفَع بالتقنيات غير الناضجة وحتى الخطرة للخدمة، فمخاطر عدم القيام بأي شيء أكبر. تبدو دُوَل بأكملها كفئران في تجارب اجتماعية واسعة النطاق. ماذا قد يحدث عندما يعمل الجميع من المنزل ويتواصلون فقط عن بُعد؟ ماذا قد يحدث عندما تُقدّم كل المدارس والجامعات محتواها مباشرة على الإنترنت؟
في الأوقات العادية، لن توافق الحكومات والشركات والمجالس التعليمية على إجراء مثل هذه التجارب. لكن هذه الأوقات ليست عادية. في وقت الأزمة هذا، نواجه خيارين مهمين بشكل خاص. الخيار الأول بين المراقبة الشمولية وتمكين المواطنين. والثاني بين العزلة القومية والتضامن العالمي.
محتويات المقال :
المراقبة الحيوية أو “المراقبة تحت الجلد”
من أجل وقف الوباء، يجب على جميع السكان الامتثال لإرشادات معينة. هناك طريقتان رئيسيتان لتحقيق ذلك. إحدى الطرق هي أن تراقب الحكومة الشعب، وتعاقب أولئك الذين يخالفون القواعد. اليوم، ولأول مرة في تاريخ البشرية، تتيح التكنولوجيا مراقبة الجميع طوال الوقت. قبل خمسين عامًا، لم يكن باستطاعة المخابرات السوفيتية KGB مراقبة 240 مليون مواطن سوفيتي على مدار 24 ساعة، ولا يمكن للـ KGB معالجة جميع المعلومات التي تم جمعها بشكل فعّال. اعتمدت وكالة المخابرات السوفيتية (KGB) سابقًا على عملاء ومحللين بشريين، ولم تتمكن من توظيف شخص لمراقبة كل مواطن. ولكن يمكن للحكومات الآن أن تعتمد على أجهزة استشعار وخوارزميات قوية في كل مكان بدلاً من الأشخاص.
استخدمت عدة حكومات بالفعل أدوات المراقبة الجديدة في معركتها ضد جائحة فيروس الكورونا. أبرز حالة هي الصين؛ من خلال مراقبة الهواتف الذكية للأشخاص عن كثب، والاستفادة من مئات الملايين من كاميرات التعرف على الوجوه، وإلزام الأشخاص بفحص درجة حرارة أجسامهم وحالتهم الطبية والإبلاغ عنها. لا يمكن للسلطات الصينية أن تحدد فقط حاملي الفيروس المشتبه بهم، ولكن أيضًا تتبع تحركاتهم وتتعرف على أي شخص اتصلوا به. تحذّر مجموعة من تطبيقات الهاتف المحمول المواطنين من اقترابهم من المرضى والمصابين.
لا يقتصر هذا النوع من التكنولوجيا على شرق آسيا. إذ سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرًا لوكالة الأمن الإسرائيلية بنشر تكنولوجيا المراقبة المخصّصة عادة لمحاربة الإرهابيين لتعقب مرضى فيروس الكورونا المستجد. وعندما رفضت اللجنة الفرعية البرلمانية المعنية الموافقة على الإجراء، صدمها نتنياهو بـ “مرسوم الطوارئ”.
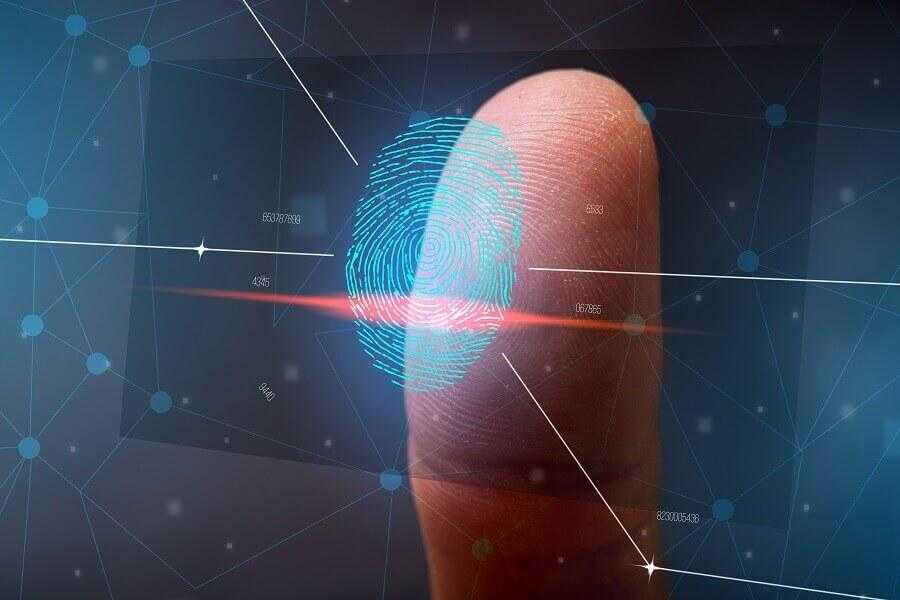
قد نتجادل بأنه لا يوجد جديد في كل هذا. ففي السنوات الأخيرة، استخدمت كل من الحكومات والشركات تقنيات أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى للتتبع والمراقبة والتلاعب بالناس. ومع ذلك، إذا لم نكن حذرين، فقد يمثل الوباء فاصلاً هامًا في تاريخ المراقبة. ليس فقط لأنها ستسمح بنشر أدوات المراقبة الجماعية في البلدان التي رفضتها حتى الآن، ولكن أكثر من ذلك لأنها تشير إلى تحوّل كبير من المراقبة “فوق الجلد” إلى “تحت الجلد” أي من المراقبة الفوقية للمراقبة الداخلية. ما نعلمه حتى الآن، هو معرفة الحكومة للروابط التي ينقرها إصبعك على شاشة هاتفك الذكي. ولكن مع اجراءات الفيروس الطارئة، يتحول الاهتمام إلى رغبة في معرفة درجة حرارة إصبعك وضغط الدم تحت الجلد.
إحدى المشاكل التي نواجهها في تشكيل موقفنا من المراقبة تكمن في عدم معرفتنا لكيفية مراقبتنا، وما قد تجلبه السنوات القادمة. تتطور تكنولوجيا المراقبة بسرعة فائقة، وما بدا أنه خيال علمي منذ 10 سنوات أصبح قديمًا اليوم. كمثال، تخيّل حكومة افتراضية تطالب بأن يرتدي كل مواطن سوارًا بيولوجيًا يراقب درجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة في اليوم. تُجمَع البيانات الناتجة وتُحلَّل بواسطة الخوارزميات الحكومية، وستعرف الخوارزميات أنك مريض حتى قبل أن تعرف أنت. كما ستعرف أيضًا أين كنت، ومن قابلت. يمكن تقصير سلاسل العدوى بشكل كبير، بل ويمكن كسرها تمامًا. بمقدورنا القول أن مثل هذا النظام قادر على إيقاف الوباء في غضون أيام. تبدو الأمور رائعة، أليس كذلك؟
لم تدرك أن هذا سيعطي الشرعية لنظام مراقبة جديد مرعب. إذا كنت تعلم، على سبيل المثال، أنني نقرت على رابط Fox News بدلاً من رابط CNN، فيمكن هذا أن يخبرك شيئًا عن آرائي السياسية، وربما يكشف لك عن شخصيتي “وهو ما حدث مع Cambridge analytica”. ولكن إذا تمكنت من مراقبة ما يحدث لدرجة حرارة جسدي وضغط الدم ومعدل ضربات القلب أثناء مشاهدة مقطع الفيديو، فيمكنك معرفة ما يجعلني أضحك أو أبكي، وما قد يجعلني غاضبًا حقًا.
من المهم أن نتذكر أن الغضب والفرح والملل والحب هي ظواهر بيولوجية مثل الحمى والسعال. يُمكن للتكنولوجيا نفسها التي ترصُد السعال أن تحدد الضحكات أيضًا. إذا بدأت الشركات والحكومات في جمع بياناتنا البيومترية “الحيوية” بشكل جماعي، فيمكنهم التعرف علينا بشكل أفضل بكثير مما نعرف حتى أنفسنا، ومن ثَمّ لا يمكنهم فقط التنبؤ بمشاعرنا ولكن أيضًا التلاعب بها وبيعنا أي شيء يريدونه – سواء كان ذلك منتجًا أو شخصية سياسية. ستجعل المراقبة البيومترية أساليب Cambridge Analytica تبدو وكأنها من العصر الحجري. تخيّل كوريا الشمالية في عام 2030، عندما يضطر كل مواطن إلى ارتداء سوار المراقبة البيومترية على مدار 24 ساعة في اليوم. حينها، إذا استمعت إلى خطاب القائد العظيم والتقط السوار علامات الغضب، فقد انتهت حياتك.

يمكنك بالطبع أن تجعل قضية المراقبة البيومترية بمثابة إجراء مؤقت يُتّخذ أثناء حالة الطوارئ. ستزول المراقبة حالما تنتهي حالة الطوارئ. لكن للأسف، للتدابير المؤقتة عادة سيئة في تجاوز حالات الطوارئ، خاصة وأن هناك دائمًا حالة طوارئ جديدة تلوح في الأفق. على سبيل المثال، أعلنت إسرائيل، حالة الطوارئ خلال حرب الاستقلال عام 1948، والتي بررت مجموعة من الإجراءات المؤقتة مثل الرقابة على الصحافة ومصادرة الأراضي إلى اللوائح الخاصة لصنع الحلوى (أنا لا أمزح). كسبت حرب الاستقلال منذ فترة طويلة، لكنها لم تعلن أبدًا انتهاء حالة الطوارئ، وفشلت في إلغاء العديد من الإجراءات “المؤقتة” منذ عام 1948 (أُلغي مرسوم الطوارئ في عام 2011).
عندما تنخفض الإصابة بفيروس الكورونا المستجد إلى الصفر، يُمكن لبعض الحكومات المتعطشة للبيانات أن تتذرّع بحاجتها إلى إبقاء أنظمة المراقبة البيومترية في مكانها لخشيتها من حدوث موجة ثانية من الفيروس مثلاً، أو لوجود سلالة جديدة من فيروس إيبولا تتطور في وسط أفريقيا، أو لأن …. أعتقد أنك قد فهمت الفكرة. كانت هناك معركة كبيرة تدور رحاها في السنوات الأخيرة حول “حق الخصوصية”، وقد تصبح أزمة الفيروس نقطة تحوّل في المعركة. فعندما يُتاح للأشخاص الاختيار بين الخصوصية والصحة، فعادة ما يختارون الصحة.
شرطة الصابون
إن مطالبة الناس بالاختيار بين الخصوصية والصحة هو في الواقع أصل المشكلة، لأنه خيار زائف. يمكننا -وينبغي أن- نتمتع بالخصوصية والصحة معًا. يمكننا أن نختار حماية صحتنا ووقف وباء الفيروس التاجي؛ ليس عن طريق إنشاء أنظمة مراقبة استبدادية، ولكن عن طريق تمكين المواطنين. في الأسابيع الأخيرة، نظمت كوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة بعض أنجح الجهود المبذولة لاحتواء وباء الفيروس التاجي. فبالرغم من استخدام هذه البلدان لبعض تطبيقات التتبع، إلا أنها اعتمدت بشكل أكبر على تكثيف اختبارات الفيروس، وعلى تقارير صادقة، وعلى التعاون المتبادَل مع جمهور تمت توعيته. المراقبة المركزية والعقوبات القاسية ليست الطريقة الوحيدة لجعل الناس يمتثلون للإرشادات المفيدة. يمكن للمواطنين إذا عرفوا الحقائق العلمية، ووثقوا في السلطات العامة وما تخبرهم به من حقائق، أن يفعلوا الشيء الصحيح حتى بدون أن يراقبهم الأخ الأكبر “تعبير من رواية 1984 يستخدم للإشارة إلى مراقبة السلطة للمواطنين بهدف توجيههم والسيطرة عليهم”. عادة ما يصبح جمهور من أصحاب الدوافع الذاتية المستنيرة أكثر قوة وفعالية بكثير من جمهور من الخاضعين لقوة الشرطة والجاهلين. ضع في اعتبارك مثال غسل الأيدي بالصابون، “هل يستوجب علينا تعيين شرطة خاصة لإجبار المواطنين على غسل أيديهم بالصابون؟”. كان هذا أحد أعظم التطورات على الإطلاق في نظافة الإنسان، إذ ينقذ ملايين الأرواح كل عام. بينما نعتبر غسل الأيدي بالصابون أمرًا مُسلّمًا به الآن، لكن لم تُكتَشف أهميته علميًا إلا في القرن التاسع عشر. في السابق، حتى الأطباء والممرضات انتقلوا من عملية جراحية إلى أخرى دون غسل أيديهم. واليوم يغسل مليارات الأشخاص أيديهم يوميًا، ليس لأنهم يخافون من شرطة الصابون، ولكن لأنهم يفهمون الحقائق. أغسل يدي بالصابون لأنني سمعت عن الفيروسات والبكتيريا، أفهم أن هذه الكائنات الدقيقة تسبب الأمراض، وأنا أعلم أن الصابون يمكن أن يزيلها. ولكن لتحقيق مثل هذا المستوى من الامتثال والتعاون، فأنت بحاجة إلى الثقة. يحتاج الناس إلى الثقة بالعلم، والثقة بالسلطات العامة، والثقة بوسائل الإعلام. على مدى السنوات القليلة الماضية، قوّض السياسيون غير المسؤولين عمدًا الثقة في العلوم والسلطات العامة ووسائل الإعلام. الآن قد يميل هؤلاء السياسيون غير المسؤولين إلى السير في الطريق السريع نحو الاستبداد، بحجة أنه لا يمكنك الوثوق في الجمهور لفعل الشيء الصحيح.
عادة، لا يمكنك إعادة بناء الثقة التي تآكلت لسنوات بين عشية وضحاها. ولكن ما نحن فيه ليس بأجواء عادية. في الأزمات، يمكن للعقول أيضًا أن تتغير بسرعة. يُمكن أن تقع في شجار مرير مع أشقائك لسنوات، ولكن بمجرد حدوث طارئ، تكتشف فجأة خزّانًا خفيًّا من الثقة والوُد، وتُهرعوا لمساعدة بعضكم البعض. لم يفت الأوان لإعادة بناء ثقة الناس في العلوم والسلطات العامة ووسائل الإعلام، بدلاً من بناء نظام مراقبة. يجب علينا بالتأكيد الاستفادة من التقنيات الجديدة أيضًا، ولكن هذه التقنيات يجب أن تُمكّن المواطنين. أنا أؤيد مراقبة درجة حرارة جسمي وضغط دمي، ولكن لا ينبغي استخدام هذه البيانات لترسيخ حكومة قوية، ولكن ينبغي أن تُمكنني هذه البيانات من اتخاذ خيارات شخصية أكثر استنارة، وكذلك تُمكنني من محاسبة الحكومة على قراراتها.
إذا تمكنت من تتبع حالتي الطبية الخاصة على مدار 24 ساعة في اليوم، فلن تتوقف معرفتي عند كوني خطرًا صحيًا على الآخرين، ولكن ستمتد إلى معرفتي بأي العادات تساهم في تحسين حالتي الصحية. وإذا تمكنت من الوصول إلى إحصاءات موثوقة حول انتشار الفيروس وتحليلها، فسأتمكن من الحكم ما تخبرني به الحكومة من حقائق وما إذا كانت تتبنى السياسات الصحيحة لمكافحة الوباء أم لا. عندما يتحدث الناس عن المراقبة، تذكّر أن نفس تكنولوجيا المراقبة يمكن للحكومات استخدامها لمراقبة الأفراد – ويمكن للأفراد أيضًا استخدامها لمراقبة الحكومات.
وبالتالي فإن وباء الفيروس التاجي هو اختبار رئيسي للمواطنة. يجب على كل منا في الأيام المقبلة أن يختار الثقة في البيانات العلمية وخبراء الرعاية الصحية مقابل نظريات المؤامرة التي لا أساس لها والسياسيين الذين يخدمون أنفسهم. إذا فشلنا في اتخاذ القرار الصحيح، فقد نجد أنفسنا نبيع أغلى حرياتنا، معتقدين أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحماية صحتنا.
نحن بحاجة إلى خطة عالمية
الخيار الثاني المهم الذي نواجهه هو بين العزلة الوطنية والتضامن العالمي. إن كلا من الوباء نفسه والأزمة الاقتصادية الناتجة عنه مشكلتان عالميتان. لا يمكن حل أي منهما بشكل فعال إلا من خلال التعاون العالمي.
أولاً وقبل كل شيء، من أجل هزيمة الفيروس، نحتاج إلى مشاركة المعلومات عالميًا. هذه هي الميزة الكبرى للبشر على الفيروسات. لا يمكن للفيروس التاجي في الصين والفيروس التاجي في الولايات المتحدة تبادل النصائح حول كيفية إصابة البشر. ولكن يمكن للصين أن تُعلم الولايات المتحدة العديد من الدروس القيّمة حول الفيروس التاجي وكيفية التعامل معه. ما يكتشفه طبيب إيطالي في ميلانو في الصباح الباكر قد ينقذ الأرواح في طهران في المساء. عندما تتردد حكومة المملكة المتحدة بين العديد من السياسات، يمكنها الحصول على المشورة من الكوريين الذين واجهوا بالفعل معضلة مماثلة قبل شهر. ولكن لكي يحدث هذا، نحتاج إلى روح من التعاون والثقة العالميين.
يجب على البلدان أن تبدي استعدادًا لتبادل المعلومات بشكل مفتوح وتواضعًا للحصول على المشورة، ويجب أن تمتلك القدرة على الثقة في البيانات والأفكار التي تتلقاها. نحتاج أيضًا إلى جهد عالمي لإنتاج وتوزيع المعدات الطبية، وعلى الأخص مجموعات الاختبار وأجهزة التنفس. فبدلاً من محاولة كل دولة القيام بذلك محليًا وتكديس أي معدات يمكنها الحصول عليها، يمكن لجهد عالمي مُنسّق أن يُسرّع الإنتاج إلى حد كبير، ويضمن توزيع المعدات المُنقِذة للحياة بشكل أكثر عدالة. مثلما تقوم الدول بتأميم الصناعات الرئيسية خلال الحرب، فقد تتطلب منا الحرب البشرية ضد الفيروس التاجي “إضفاء الطابع الإنساني” على خطوط الإنتاج الضرورية. يجب أن تستعد الدولة الغنية صاحبة العدد القليل من حالات الإصابة بالفيروس لإرسال معدات ثمينة إلى بلد فقير يعاني من كثرة الحالات، واثقة من أن الدول الأخرى ستهب لمساعدتها إذا احتاجت المساعدة لاحقًا.

قد نفكر في جهد عالمي مماثل لتجميع العاملين في المجال الطبي. يُمكن للبلدان الأقل تأثراً في الوقت الحالي أن ترسل موظفين طبيين إلى المناطق الأكثر تضرراً في العالم، من أجل مساعدتهم وقت الحاجة، ومن أجل اكتساب خبرة قيّمة. وتبدأ المساعدة في التدفق في الاتجاه المعاكس بانعكاس التحولات الوبائية لاحقًا.
هناك حاجة حيوية للتعاون العالمي على الصعيد الاقتصادي أيضًا. بالنظر إلى الطبيعة العالمية للاقتصاد وسلاسل التوريد، سنصبح أمام فوضى وأزمة عميقة إذا حاولت كل حكومة بشكل منعزل معالجة الوضع في تجاهل تام للحكومات الأخرى. نحن بحاجة إلى خطة عمل عالمية وبسرعة.
شرط آخر هو التوصل إلى اتفاق عالمي بشأن السفر، فتعليق جميع الرحلات الدولية لأشهر سيتسبب في صعوبات هائلة، ويعرقل الحرب ضد فيروس كورونا. تحتاج الدول إلى التعاون من أجل السماح لعدد قليل على الأقل من المسافرين الأساسيين بمواصلة عبور الحدود مثل العلماء والأطباء والصحفيين والسياسيين ورجال الأعمال. يُمكن القيام بذلك من خلال التوصل إلى اتفاقية عالمية بشأن الفحص المسبق للمسافرين في بلدهم. ستكون أكثر استعدادًا لقبول المسافرين في بلدك إذا تأكدت من فحصهم بعناية قبل صعودهم على متن الطائرة.
في الوضع الحالي ولسوء الحظ، لا تفعل البلدان أي من هذه الأشياء. لقد أصيب المجتمع الدولي بالشلل الجماعي. أليس منكم رجل رشيد؟ كان المرء يتوقع أن يرى قبل أسابيع اجتماع طارئ للقادة العالميين للتوصل إلى خطة عمل مشتركة. تمكن قادة مجموعة السبع من تنظيم مؤتمر بالفيديو هذا الأسبوع فقط، ولم تسفر عنه أي خطة من هذا القبيل.
في الأزمات العالمية السابقة – مثل الأزمة المالية لعام 2008 ووباء إيبولا 2014 – تولت الولايات المتحدة دور القائد العالمي. لكن الإدارة الأمريكية الحالية تخلت عن منصب القائد. لقد أوضحت أنها تهتم بعظمة أمريكا أكثر من اهتمامها بمستقبل البشرية.
لقد تخلت هذه الإدارة حتى عن أقرب حلفائها، عندما حظرت جميع رحلات السفر من الاتحاد الأوروبي، ولم تكلف نفسها عناء إعطاء الاتحاد الأوروبي إشعارًا مسبق – ناهيك عن التشاور مع الاتحاد الأوروبي حول هذا الإجراء الجذري. قامت بتخريب علاقاتها مع ألمانيا عندما قدّمت مليار دولار إلى شركة دواء ألمانية لشراء حقوق احتكار لقاح جديد Covid-19. حتى لو قامت الإدارة الحالية في نهاية المطاف بتغيير مسارها ووضعت خطة عمل عالمية، فإن القليل سيتّبع زعيمًا لا يتحمل المسؤولية مطلقًا، ولا يعترف أبداً بالأخطاء، ينسب كل الفضل لنفسه ويترك كل اللوم للآخرين.
إذا لم يُملأ الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة من قبل دول أخرى، فلن تتوقف صعوبة الأمر على إيقاف الوباء الحالي فحسب، بل سيستمر إرثه في تسميم العلاقات الدولية لسنوات قادمة. ومع ذلك، فكل أزمة هي فرصة. نأمل أن يساعد الوباء الحالي البشرية على إدراك الخطر الحاد الذي يشكله الانقسام العالمي.
تحتاج البشرية إلى الاختيار. هل نسير في طريق الانقسام، أم سنتبنى طريق التضامن العالمي؟ إذا اخترنا الانقسام، فلن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الأزمة فحسب، بل سيؤدي على الأرجح إلى كوارث أسوأ في المستقبل. إذا اخترنا التضامن العالمي، فسننتصر على الفيروس التاجي وعلى جميع الأوبئة والأزمات والتحديّات المستقبلية التي قد تهاجم البشرية في القرن الحادي والعشرين.
تُرجم عن مقال الكاتب يوفال نوح حراري في Financial Times
سعدنا بزيارتك، جميع مقالات الموقع هي ملك موقع الأكاديمية بوست ولا يحق لأي شخص أو جهة استخدامها دون الإشارة إليها كمصدر. تعمل إدارة الموقع على إدارة عملية كتابة المحتوى العلمي دون تدخل مباشر في أسلوب الكاتب، مما يحمل الكاتب المسؤولية عن مدى دقة وسلامة ما يكتب.




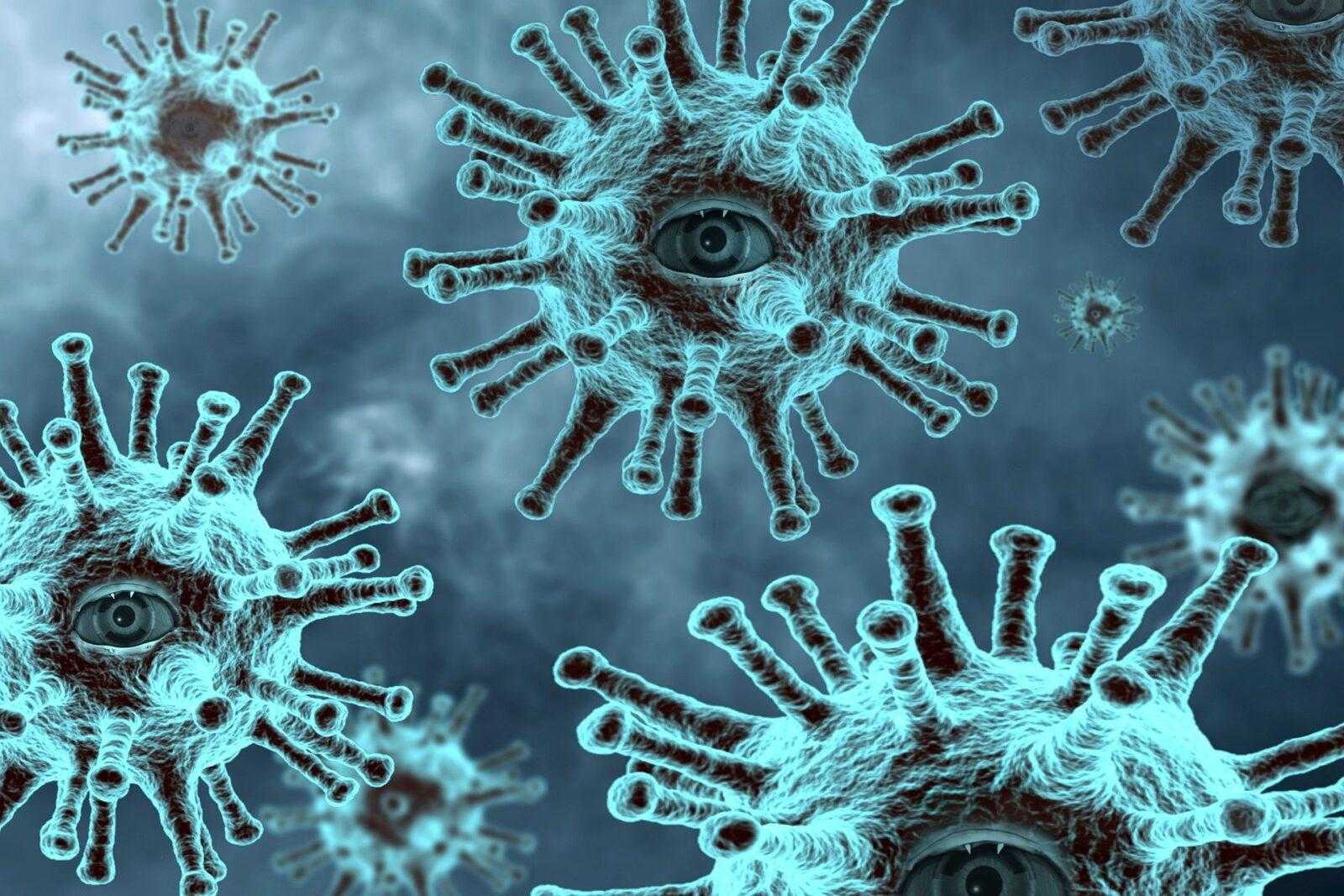
التعليقات :