عندما نلقي نظرة للوراء وتحديدًا إلى أيام المدرسة. من المحتمل أن تكون أقوى ذكرياتنا مزيجًا من المناسبات الهامة كالرحلات والمسرحيات والأيام الرياضية إلى جانب الكثير من الأحداث الشخصية المليئة بالعواطف القوية.
أشياء حدثت وكانت مضحكة حقًا أو حزينة، أو جعلتنا نشعر بالحماس أو الاهتمام أو البهجة أو الغضب. نحن لا نتذكر عادة الأمور بوضوح، خصوصًا إن كان ذلك تعلمًا فعليًا لمادة الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو تكنولوجيا التصميم. قد نتذكر الحكايات المسلية التي مرّت أثناء الدروس، أو قد يستمر شعورنا بالضيق من مظالم الماضي، أو قد نُكوّن انطباعًا غامضًا عن الجلوس في مختبر العلوم، مع مقتطفات عابرة من ذكريات هذه التجربة أو تلك.
كل هذا يقودنا إلى وضع فرضية معقولة تمامًا مفادها أنه إذا أردنا أن يتذكر الطلاب ما نعلمهم إياه، فإننا نحتاج إلى جعل دروسنا أشبه بأحداثٍ مميزة. أو على الأقل، اختيار شيء ما مثيرٍ أو غير معتاد وتضمينه في الدروس. في هذا العرض، ستجد نموذجا لإنشاء دروس لا تنسى.
محتويات المقال :
كيف تعمل الذاكرة؟
بقدر ما يبدو هذا معقولًا، إلا أنه خرافة. فالذاكرة البشرية تعمل بطريقتين مختلفتين، كلتاهما صحيحتان على حد سواء، ولكن إحداهما أفضل بكثير في تمكيننا من نقل ما تعلمناه إلى سياقات جديدة. يعتبر هذا النقل شرطًا أساسيًا للإبداع والتفكير النقدي. يُعرف شكلا الذاكرة بالذاكرة العرضية و الذاكرة الدلالية.
1- الذاكرة العرضية
الذاكرة العرضية هي ذاكرة “حلقات” أو سيرتنا الذاتية هذا الشكل من الذاكرة لا يتطلب جهدًا من جانبنا، إنه يحدث ببساطة. ليس علينا أن نحاول بوعي أن نتذكر ما حدث بالأمس، لأن هذه الذكريات تحدث تلقائيًا.
ولكن هناك جانبٌ سلبيٌ في الأمر، فالذاكرة العرضية “تأتي بسهولة وتذهب بسهولة”. فإذا حاولت تذكر ما تناولته على الغداء بالأمس، فربما ستتذكر. أمّا إذا حاولت أن تتذكر ما تناولته على الغداء قبل عام من اليوم -ما لم يكن ذلك تاريخًا مهمًا للغاية أو وجبة غداء جديرة بالملاحظة بشكل خاص- فلن يكون لديك أي فكرة.
2- الذاكرة الدلالية
تنطوي الذاكرة الدلالية على عمل أكثر صعوبة، إذ علينا بذل الجهد لخلق ذكريات دلالية. هذا هو نوع الذاكرة التي نستخدمها عندما ندرس شيئًا بوعي لأننا نريد تذكره. وذلك على عكس الذاكرة العرضية. ومع ذلك، فالإتجاه تصاعدي إذ إنّ الجهد المبذول ينتج عنه ذاكرة طويلة الأمد.
هل سبق لك أن شاركت في دورة استمتعت فيها حقًا بالاستماع إلى المتحدث؟ ووجدت أن الموضوع مثير للاهتمام و أنّ المقدم مسلٍ وجذاب. ومع ذلك، عندما حاولت أن تشرح لشخص ما في اليوم التالي عمّ دارت الدورة، فإن كل ما تبقى في ذهنك حقًا هو انطباع غامض عن مشاعرك خلال ذلك اليوم، مخلوطًا بالمقتطف الغريب من المحتوى.
أنت تعلم أن الدورة كانت جيدة حقًا ولكن لا يمكنك تفسير ما كانت عليه في الواقع وراء أكثر التأكيدات العامة. وذلك لأن ذكرياتك عند هذه النقطة تكون عرضية بشكل أساسي وتتلاشى بالفعل. من المحتمل أن يحدث هذا على وجه الخصوص إذا استمعت إلى المتحدث فقط دون تدوين بعض الملاحظات! ولم تقم بأي نشاط خلال اليوم ذلك يجعلك تفكر مليًا في المحتوى. وحتى إن فعلت ذلك، إذا لم تعد قراءة الملاحظات في وقت لاحق، أو المدونات التي ذُكرت، أو تخطط لاجتماع فريق عمل لإخبار الآخرين بما تعلمته، إذا لم تبذل بعض الجهد في إعادة النظر في رسالة المتحدث، فإن ذاكرتك الخاصة بالتفاصيل الفعلية ستتلاشى بسرعة مما سيترك لك ذكريات جميلة ليوم ممتع ومثير للاهتمام.
إن الذاكرة العرضية سياقية إلى حد كبير -فالذكريات تأتي مع التجارب الحسية والعواطف التي مررنا بها في وقت التجربة. لذلك عندما نتذكر الدورة، نتذكر تكييف الهواء الرديء والغداء المدهش والقرطاسية الرائعة. وقد يزعجنا أن نتذكر هذه الأشياء بشكل أكثر من أردناه.
.عندما يطلب المعلمون من الطلاب تذكر ما تعلموه في اليوم السابق، يتذكر الطلاب جميع الأشياء: طريقة كتابتك للملاحظات، وتأخر أحد الطلاب، وانسكاب قهوتك، ورواية أحدهم لنكتة مضحكة. أما محتوى الدرس الفعليّ فيكون تذكره أضعف بكثير.
يتم تشغيل الإشارات العاطفية والحسية عندما نحاول استرجاع ذاكرة عرضية. تكمن المشكلة في أن الطلاب يتذكرون أحيانًا العلامات السياقية ولكن ليس التعلم الفعلي. إنّ الذاكرة العرضية مرتبطة بالسياق لدرجة أنها لا تصلح لتذكر الأشياء بمجرد أن يصبح هذا يذهب السياق. وهذا يعني أن لها قيودًا خطيرة من حيث فائدتها باعتبارها الاستراتيجية الرئيسية لتعليم الأطفال، لأن كل ما يتم تذكره مرتبط جدًا بالسياق الذي تم تدريسه فيه. هذا لا يجعل التعلم مرنًا وقابلًا للتحويل ويمكن تطبيقه في سياقات وظروف مختلفة. ومع ذلك، فإن قابلية النقل هذه هي الشرط الأساسي للإبداع والتفكير النقدي.
من حسن الحظ أنّ لدينا أيضًا ذاكرة دلالية، لأن الذاكرة الدلالية ليس لها حدود الذاكرة العرضية، فالذكريات الدلالية خالية من السياق. يتم تحرير الذكريات الدلالية من السياق العاطفي والمكاني/الزمني الذي اُكتسبت فيه لأول مرة. و يتم تخزين المفهوم في الذاكرة الدلالية، وبذلك تصبح أكثر مرونة وقابلية للتحويل بين السياقات المختلفة. لذافإن الذاكرة الدلالية مركزية للتعلم على المدى الطويل: التعلم الذي يمكن استخدامه في سياقات جديدة لحل مشاكل غير متوقعة. إن الذاكرة الدلالية هي ما نستخدمه عندما نحل المشكلات أو نكون في صدد عمل إبداعيّ. يتضمن ذلك تطبيق شيء ما تم تعلمه في سياق محدّد إلى سياق آخر جديد. وعلى النقيض من ذلك، فإن الذكريات العرضية ليست مرنة ولا تنتقل بسهولة، لأنها ترتكز على التفاصيل.
وهذا ما يفسر الإحباط الذي يشعر به المعلمون في بداية كل عام دراسي عندما يبدو أنّ الأطفال -الذين ثبت أنهم أكفاء- ليس لديهم أي فكرة عما درسوه في السابق. ليس الأمر أن معلمهم السابق كان يكذب أو يخادع عندما قال إنهم أكفاء. السبب هو أن المعلم السابق لم يدرك أن هذا الفهم لم يكن آمنًا بعد في الذاكرة الدلالية وأنه كان لا يزال يعتمد بشكل كبير على الذاكرة العرضية.وأنه يعتمد بشكل كبير على الإشارات السياقية القوية التي يجب تذكرها. انقل الطفل إلى فصل دراسي مختلف، مع مدرس مختلف، بجانب زملاء مختلفين، وبدون السياق المألوف، وستجد ببساطة أنه لايمكنه تذكر المعرفة.
عندما ينتقل الأطفال من فصل إلى آخر فهذا أمر سيئ ولكن الأمر يزداد سوءًا عندما يغير الأطفال المدارس، كانتقالهم من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية. يختلف هنا السياق بشكل كبير: مبنى مختلف، مسيرة مختلفة، زي موحد، الكثير من الأشياء التي لم تعد مألوفة. لا عجب في أن معلمي المرحلة الثانوية يعتقدون غالبًا أن معلمي المرحلة الابتدائية يبالغون في تقدير ما يعرفه تلاميذهم السابقون. فعندما يزول السياق المألوف، يتذكر التلاميذ فقط ما خُزن بشكل آمن في الذاكرة الدلالية، وهو ما يمكنهم نقله إلى الحياة في السنة السابعة.
يتطلب تكوين الذكريات الدلالية العمل والممارسة، على عكس الذكريات العرضية. فإذا كنت تريد أن تتذكر شيئًا ما، فأنت بحاجة إلى التفكير فيه، وليس مجرد تجربته. يشرح عالم النفس المعرفي دانيال ويلينجهام《Daniel Willingham》 أن “الذاكرة هي بقايا الفكر”. كلما فكرت في شيء ما، كلما زاد احتمال تذكره. لذا فإنّ على المدرسين التأكد من أن الدروس تمنح الطلاب الفرصة للتفكير في الأشياء التي نريدهم أن يتذكروها، بدلاً من بعض الأشياء الخارجية الأخرى. نحتاجهم أن يفكروا في رسالة الدرس، بدلاً من الوسيلة التي نستخدمها في الدرس. هذا هو المكان الذي يمكن فيه لدروس “المرح” أن تمنع دون قصد حدوث التعلم. إذا كانت الوسيلة المختارة لتقديم الدرس مزعجة للغاية، فهذا هو ما سيفكر فيه الطلاب، بدلاً من أي شيء نريده بالفعل أن يتعلموه. على سبيل المثال، أتذكر شخصًا يقترح استخدام مسدسات الماء لتعليم الأطفال الزوايا. هذا اقتراح لا يخلو من بعض الجدارة. على وجه الخصوص، أحب الطريقة التي يتم بها تدريس الزاوية هنا عموديًا بدلاً من أفقي فقط كما هو معتاد مع الورق والقلم الرصاص والمنقلة. ومع ذلك، ربما يكون مؤلف هذا الاقتراح معلمًا أكثر مهارة من معظمهم، ولكن لا يمكنني التفكير في أن العديد من الأطفال قد يفكرون في فرص بخ الماء عن طريق الخطأ أكثر من طبيعة الزوايا الحادة. حتى النشاط الأقل مغامرة – لعبة الرياضيات على سبيل المثال – ينطوي على خطر أن يفكر الأطفال بجدية في القواعد بدلاً من الرياضيات الفعلية. هذه ليست مشكلة إذا قرر المعلم التضحية بدرس واحد لتعلم قواعد اللعبة التي سيتم استخدامها بعد ذلك بشكل متكرر على مدار العام. ولكنه يمثل مشكلة كبيرة إذا لم يكن المدرسون متيقظين لإمكانيات أنهم قد يفسدون التعلم عن غير قصد بجعل وسيلة التعلم أكثر بروزًا من الرسالة الفعلية. فعندما يخطط المعلمون للدروس، يجب أن يعوا ما سيفكر فيه الأطفال خلال كل جزء من الدرس، بدلاً من ما سيشعرون به أو يفعلونه. هل قمت بتخطيط أنشطة تضمن للأطفال التفكير بجدية في الأشياء الصحيحة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا تتفاجأ عندما يتذكر الأطفال القليل جدًا حول الدرس المحدد.
تتركز بعض أنواع الأنشطة على التفكير الجاد، ولكن ليس دائمًا حول الأشياء المركزية التي نريد أن يفهمها الأطفال. على سبيل المثال، ينطوي إجراء تجارب علمية عملية على الكثير من التفكير في التخطيط، وما يجب القيام به بعد ذلك، ومراقبة ما يحدث. في الواقع، تتطلب العناصر العملية الكثير من الطاقة العقلية لدرجة أنه لا يوجد الكثير من النطاق الترددي المعرفي المتبقي للتفكير فعليًا في المفاهيم التي تهدف التجربة إلى إثباتها. عندما قام Ofsted《المكتب البريطاني لمعاير التعليم ومهارات الأطفال》 بالتحقيق في تدريس العلوم في المدارس الابتدائية، وجد أن العديد من المدارس حاولت عن طريق الخطأ تعليم مفاهيم العلوم بشكل كامل تقريبًا من خلال التجارب العملية: المفهوم الخاطئ هنا هو أن “العمل علميًا” يصبح آلية لتعليم المعرفة والمفاهيم. ومع ذلك، فإن الاقتراب من تدريس العلوم بهذه الطريقة يؤدي إلى مشكلة متكررة وهي أن التلاميذ ينخرطون في تجارب لاتنسى، وبالمقابل ليس لايستطيعون تذكر المعرفة الأساسية المقصود تعلمها من التجارب. على سبيل المثال، عندما استجوب المفتشون التلاميذ خلال زيارات البحث، كان بإمكان التلاميذ تذكر المهمة التي تم تنفيذها بسهولة، لكنهم وجدوا صعوبة في شرح كيفية عمل تلك المهمات.
وهذا لا يعني أنه لا ينبغي للأطفال إجراء تجارب علمية، ولكن يجب على المعلمين أن يدركوا تمام الإدراك أنه من غير المحتمل أن يكتسب الطلاب فهمًا للمفاهيم العلمية ما لم يتم إجراء التجارب بعد تدريس هذه المفاهيم. فبمجرد أن تصبح المفاهيم العلمية مفهومة، يصبح الأطفال أكثر قدرة على “التفكير مثل العلماء” مع الفائدة الإضافية التي مفادها أن النشاط العملي يعزز فهم التعلم السابق.
وينطبق الشيء نفسه على الأنشطة التي تتطلب من الأطفال البحث عن المعلومات بأنفسهم. إذا تم ذلك كوسيلة للحصول على المعلومات في المقام الأول، فمن غير المحتمل أن يترك الجهد المعرفي لتحديد المعلومات الصحيحة مساحة للأطفال ليتذكروا الكثير عما اكتشفوه. سوف يفكر الأطفال في المكان الذي يمكنهم فيه العثور على ما يحتاجون إلى اكتشافه وما إذا كان ما يقرؤونه مناسبًا، بدلاً من التفكير فعليًا في المحتوى. إذا كان تذكر المحتوى أمرًا مهمًا يجب على المعلمين أن يضعوا في الاعتبار أن الوقت الإضافي سواء قبل أو بعد أنشطة البحث، يجب أن يُقضي في التفكير مليًا في المعلومات.
تظهر هذه المشكلة أيضًا في تدريس الرياضيات من خلال حل المشكلات. يعتقد بعض المعلمين أن المهام الغنية مثل التحقيقات حين يقوم الأطفال باكتشاف العلاقات بأنفسهم هي طريقة تعليمية أفضل بكثير من إخبار الأطفال بشكل صريح بكيفية القيام بالعمليات. يُنظر إلى الاكتشاف على أنه أكثر إبداعًا، ويتطلب المزيد من الخيال، وأكثر إثارة للاهتمام، وبالتالي من المرجح أن يؤدي إلى فهم الأطفال حقًا مفاهيم الرياضيات، بدلاً من مجرد إجراء اندفاعي. ومع ذلك، في حين أن المهام الغنية لها مكانها، إلا أنها غير مناسبة تمامًا للمرحلة الأولية من التعلم، عندما يواجه الأطفال مفهومًا للمرة الأولى. فإذا أردنا أن يصبح الأطفال مستقلين لحل المشكلات، فنحن بحاجة إلى تعليمهم بعناية وصراحة حتى تبدأ الذاكرة الدلالية في التشكل. بعكس الحدس كما قد يبدو، لا يصبح الأطفال مستقلين في حل المشاكل عن طريق حل المشاكل بشكل مستقل. هذا لأنه عندما يحاول الأطفال حل المشكلات قبل أن يعرفوا الرياضيات اللازمة للقيام بذلك، فإنهم سوف يبذلون طاقة عقلية كبيرة لتتبع ما يُقصد حله مقابل ما اكتشفوه حتى الآن، لدرجة أنهم عندما يصلون إلى الحل، سيكونون قد نسوا ما فعلوه بالضبط حتى وجدوا الإجابة أخيرًا! إن هناك الكثير من الأبحاث التي تظهر أن التدريس أكثر فاعلية عندما يشرح المعلم المواد بشكل صريح في خطوات صغيرة ومدروسة بعناية، مما يمنح الأطفال الكثير من الفرص للممارسة قبل الانتقال إلى الخطوة الصغيرة التالية. هذا صحيح بشكل خاص في مرحلة اكتساب المعرفة المبكرة للتعلم.
حتى إذا قُسمت مواد الدروس إلى خطوات صغيرة وأُشرك الأطفال في التفكير في الأشياء الصحيحة، فقد يظل المعلمون ممتلكين للخبرة المألوفة. وفي نهاية سلسلة من الدروس حول موضوع معين، يشعر المدرس بثقة معقولة في أن معظم الفصل تعلموا كيفية القيام بأي شيء كانوا يتعلمونه، على سبيل المثال- نظرية الشبكة-. قد يؤدي الأطفال أداءً جيدًا بشكل معقول في تقييم نهاية الوحدة. ومع ذلك، عند إعادة النظر في الموضوع بعد بضعة أسابيع، لا يستطيع الأطفال تذكر كيفية تنفيذ نظرية الشبكة، ليس هذا فحسب، ولكن العديد منهم سينكرون انهم سمعوا بالنظرية من قبل! يمكن أن يترك هذا الموقف المعلمين محبطين ومتسائلين عن مكان الخطأ الذي ارتكبوه.
إذا لم يعد المعلمون النظر في المفاهيم مرة أخرى في وقت لاحق. بعد مرور بعض الوقت على آخر شرح للمفهوم، فمن المحتمل أن لا تكون الذاكرة الدلالية قوية بما يكفي للقيام بالمهمة التي نحتاجها للقيام بها. فنحن بحاجة إلى مضاعفة المرّات التي يتعين فيها على التلاميذ التفكير بجدية حول الأشياء المهمة التي نريدهم أن يتعلموها. فهل نعطي الطلاب فرصًا للتفكير في المفاهيم في بيئة أقل حدة؟ ليس من الصعب تنفيذ نظرية الشبكة في منتصف الدرس حيث يقوم المعلم بوضع نموذج لكيفية تنفيذ طريقة الشبكة. ولكن لبناء ذاكرة دلالية قوية، يحتاج الطلاب إلى فرص للقيام بالأشياء عندما يكون التدريس المحدد لكيفية القيام بها أقل حداثة. كما أنهم بحاجة إلى فرص للقيام بها عندما تكون أقل حدة. على سبيل المثال، لايجب عليك اخبارهم – “لحل هذا الأمر، ستحتاج إلى الضرب، باستخدام نظرية الشبكة”.
في الدروس، يقدم المعلمون جميع أنواع الأفكار والعلامات التي تحمل الأطفال إلى إجابات صحيحة. هذا جيد كخطوة أولى، ولكن ما لم يكن لدى المعلمين أيضًا استراتيجيات تمكن المتعلمين من تجاوز العمل، فقد يتم الاحتفاظ بالقليل على المدى الطويل. يشرح نيكولاس سودرستروم وروبرت بيورك《Nicholas Soderstrom and Robert Bjork explain》في مقالة عام 2015 تتحدث عن وجهات نظر حول علم النفس، الفرق بين الأداء والتعلم. فالأداء هو ما يمكن أن نراه يحدث أثناء التدريس. أمّا التعلم، من ناحية أخرى، هو شيء غير مرئي يدور داخل رؤوس الأطفال. لا يمكننا مراقبة التعلم، يمكننا فقط استنتاجه. من المحبط أن الأداء الحالي هو دليل رهيب لمعرفة ما إذا كان التعلم قد حدث بالفعل أم لا. إن المعلمون والقادة معرضون لخطر الخداع بسبب الأداء الحالي وقد يعتقدون أن التغيير في الذاكرة الدلالية طويلة المدى (المعروف أيضًا بالتعلم) قد حدث.
إنه من غير المألوف أن يختلف الناس مع هذا التأكيد على بناء الذاكرة الدلالية. في بعض الأحيان يجادل الناس “لكنني لا أتذكر أي شيء تعلمته في المدرسة”. عندما يقول الناس هذا، فإن ما يقصدونه عادة هو “ليس لدي ذكريات عرضية قوية لتعلم أشياء معينة في المدرسة”. هذا في الواقع شيء جيد يجب أن يكونوا ممتنين له. لا نريد أن نتذكر السياق جنبًا إلى جنب مع المحتوى، الأمر الذي سيعيق حقًا قدرتنا على التفكير. نحن لا نتذكر الكثير مما تعلمناه في المدرسة، ومع ذلك نحن نعرفه. هذا لأن الذاكرة العرضية للدرس الفعلي قد تلاشت منذ فترة طويلة، في حين أن الذاكرة الدلالية التي تشكلت من خلال التفكير الجاد في المحتوى-وإن كان ربما على مضض في ذلك الوقت- تستمر. هذا هو السبب في أن الناس يعرفون عن المثلثات والأكسجين، آن بولين《ملكة إنجلترا》 والمقالات القصيرة، والأرقام المربعة وبحيرات أوكسبو، وخلط الألوان وليدي ماكبث《شخصية مسرحية. هل يتذكر الناس أنهم تعلموا هذه الأشياء فعلًا؟ ربما لا، لكنهم يعرفونها (أو معظمها) وعلى الرغم من أن الشخص ربما لم يفكر في بحيرات أوكسبو لعقود، إلا أنه عند ذكر الاسم، تأتي الذاكرة بسهولة. هذا هو جمال الذاكرة الدلالية. فهي لاتحتاج أن تكون مرتبطة بفوضى عرضية. كما قال سولومون كينجزنورث《Solomon Kingsnorth》 فلديك “دليل سياحي خاص للكون، يعيش داخل عقلك” متاح على الفور.
إنّ ما تعرفه يشكل ما تراه. أنت أو أنا قد ننظر إلى جبل ونرى فقط … جبلا. بينما قد ينظر الجيولوجي إلى الجبال بشكل مختلف إلى حد ما، أما حين ينظر الدراج المتحمس فقد يرى المرء الجبل كما نراه، ومع ذلك يرى أيضًا التكوينات الصخرية، والآخر يرى نسب التروس. إن امتلاك ذاكرة لغوية مليئة بالثراء هو، كما وضعها إيان ليزلي《Ian Leslie》 في كتاب《Curious》، للوصول إلى “الواقع المعزز، كل شيء تراه يتراكب مع طبقات إضافية من المعنى والإمكانية”.
إذا كنت تعرف نوع الأشياء المذكورة أعلاه -آن بولين والفقرات وبحيرات أكسبو، على سبيل المثال- فأنت تتمتع بامتياز المعرفة. لقد تم منحك فرصًا للتفكير مليًا في الأشياء التي لا تعرفها، وبالتالي لديك مستودع كبير من الذاكرة الدلالية في متناول اليد، متاحة بسهولة وقتما تشاء. ومع ذلك، من السهل للغاية التغاضي عن هذه الميزة والتقليل إلى حد كبير من مقدار ما نعرفه في الواقع ومدى استفادتنا من مدارسنا. لأننا لا نتذكر عملية تعلم ما نعرفه، لا نتذكر الجهد الذي بذل في دراسته. قد نفترض أن الأشياء المهمة التي نعرفها قد تعلمناها بمجرد تركنا المدرسة، دون أن ندرك أن الذكريات الدلالية التي تم الحصول عليها في المدرسة هي التي خلقت الأسس التي تمكنا من البناء عليها بشكل مثمر في وقت لاحق. لو كانت الأمور على خلاف ذلك، لكانت قدرتنا على التفكير قد تقلصت إلى حد كبير. ربما اعتقدت أنه من المهم للغاية الحصول تجارب شيقة ومثيرة عند ذهابنا إلى المدرسة. وفي حين أن ذلك قد يكون ممتعًا، إلا أنه قد يترك لنا إما القدرة على التفكير أو أن نكون مبدعين حقًا، خاصة إذا كان وصولنا إلى المعرفة القوية في المنزل محدودا. قبل أن نقرر فرض أجنداتنا الخاصة على تعليم الأطفال، نحتاج إلى التحقق من ميزة المعرفة لدينا قبل اتخاذ القرارات التي ستحرم الأطفال من نصيبهم العادل من الميراث الثقافي الغني الذي يوفره عالمنا والذي يحق لهم الحصول عليه.
قد تظهر الذاكرة العرضية، للوهلة الأولى، أكثر “إنسانية” من شكلي الذاكرة، ذاكرة الناس والمشاعر والأماكن التي تجعلنا ما نحن عليه. تبدو الذاكرة الدلالية أكثر برودا وأكثر روبوتية. ومع ذلك، فإن قدرتنا المذهلة على تخزين التعلم المكتسب ثقافيًا في ذاكرتنا الدلالية هي التي تجعل النجاح مثل صورة ذهنية. إن الغرض الرئيسي من التعليم هو بناء ذاكرة دلالية قوية،فإذا نظرنا إلى المعرفة التي تراكمت عبر القرون إلى الجيل التالي: كيفية القراءة والكتابة، وكيف تعمل القصص، وكيف يستخدم المنطق الرياضي لحل المشاكل، والعلم بقوته التنبؤية المذهلةمع عدد لا يحصى من المفاهيم والأفكار والممارسات الأخرى. هذا لا يعني أن بناء الذاكرة الدلالية هو الغرض الوحيد من التعليم. فنحن نريد المساعدة في تكوين أطفال متعلمين عاطفيًا ومسؤولين أخلاقيًا أيضا. وسيتضمن ذلك التفكير في نوع الذكريات العرضية التي نحاول أن نبنيها لأطفالنا. إذا تعاملنا مع أطفالنا بلطف واحترام، فسيكون لديهم ذكريات عرضية لتعامل لطيف ومحترم، مما يزيد من احتمال معاملتهم للآخرين بلطف واحترام. وإلى جانب بناء رأس مال ثقافي في الذاكرة الدلالية، يجب بناء رأس مال الاجتماعي وأخلاقي وروحي أيضًا. في حين أن بناء الذاكرة الدلالية سيلعب دورًا مهمًا في ذلك، فإن تطوير الذاكرة العرضية أيضًا مهم، كما هو الحال مع الأبعاد الحيوية للتجربة البشرية، قد يكون تذكر السياق العاطفي أكثر أهمية.
ولا يعني ذلك أنه لا ينبغي التفكير في إنشاء نوع من التجارب التي لا تنسى والتي تحدث في الرحلات والمسرحيات وما إلى ذلك. فمثل هذه الأحداث الخاصة التي تتخلل الروتين اليومي للحياة المدرسية هي مهرجانات “عشاء عيد الميلاد” للعام الدراسي. إنها خاصة لأنها نادرة وضخمة الموارد ومختلفة. وتتناقض مع الألفة اليومية للخبز والزبدة والطبلة في الحياة المدرسية العادية. ولكن الهدف الأساسي هنا هو الخبرة اليومية.
بعض التحذيرات:
عندما نقوم بتعليم الأطفال الذين لديهم خبرة حياتية محدودة والذين لا يملكون ذكريات عرضية غنية. فسيكون الأمر الأكثر أهمية هو تقديم نوع من التجارب الغنية -الرحلات إلى شاطئ البحر، والمسرح والمعارض الفنية- لنرى أولاً الجبال والمدن والغابات. فبالنسبة لكثير من الأطفال، يعد هذا التعرض جزءًا لا يتجزأ من الحياة الأسرية. ولكن بالنسبة لآخرين، فإن الخبرة التي تتجاوز المحلية غير موجودة إلى حد كبير. في هذه الحالة، نحن مدينون للأطفال بمحاولة تقديم أنواع من الخبرة المباشرة التي توسع الآفاق. والأطفال الصغار جدًا، بغض النظر عن خلفيتهم الأسرية، لديهم تجربة حياة أقل ثراءً، لذا يحتاجون إلى تجارب لا تنسى كثيرة كنوع من “الترحيب في العالم”.
من الممكن أيضًا أن تحدث مبالغة في انفصال الذاكرة العرضية عن الدلالية. إن هناك درجة من التداخل بين الاثنتين. إنها ليست مقصورات مقاومة للماء. فعلى سبيل المثال، في إحدى التجارب، طُلب من الأشخاص إدراج أواني المطبخ. أولاً، اعتمد المشاركون على محتويات ذاكرتهم الدلالية، ولكن عندما نفذ الأمر، تحولوا إلى التفكير تحديدًا في مطابخهم الخاصة وتذكر ما كان هناك. عززوا استرجاعهم من الذاكرة الدلالية مع ذكريات عرضية محددة السياق.
إن المشاعر القوية تجعل الأشياء تلتصق بالذاكرة العرضية، مثلما يفعل التجديد. لذا فإن القيام بنوع من الأحداث الأقل روتينية أو المثيرة لاستكمال التعلم حول شيء ما قد يكمل الذاكرة الدلالية. -رحلة في نهاية موضوع كتاب على سبيل المثال. بالعودة إلى المثال المبكر: تدريس الزوايا باستخدام مسدسات الماء، قد يكون القيام بذلك بعد سلسلة من الدروس التقليدية طريقة جيدة لجني فوائد كلا شكلي الذاكرة، كما هو الحال في تجربة العلوم التي تثبت المفهوم الذي تم التعرف عليه. إنه ليس خيارًا ثنائيًا بسيطًا دائمًا عليك العمل بأحدهما فقط. وهذا لا يعني ان أسلوب الذاكرة العرضية “سيئ” أو أقل شأنا. لكن الأمر مختلف. فمن المرجح أن يؤدي البناء المتعمد للذاكرة الدلالية إلى ذاكرة طويلة الأمد ومرنة وقابلة للتحويل من وضع معظم طاقاتك في السلة العرضية، لذلك يجب أن تشكل الجزء الأكبر مما نقضي وقتنا عليه. يمكن أن تساعدنا معرفة شكلي الذاكرة في اتخاذ خيارات أكثر حكمة وإنتاجية.
المصدر: educationnext
سعدنا بزيارتك، جميع مقالات الموقع هي ملك موقع الأكاديمية بوست ولا يحق لأي شخص أو جهة استخدامها دون الإشارة إليها كمصدر. تعمل إدارة الموقع على إدارة عملية كتابة المحتوى العلمي دون تدخل مباشر في أسلوب الكاتب، مما يحمل الكاتب المسؤولية عن مدى دقة وسلامة ما يكتب.



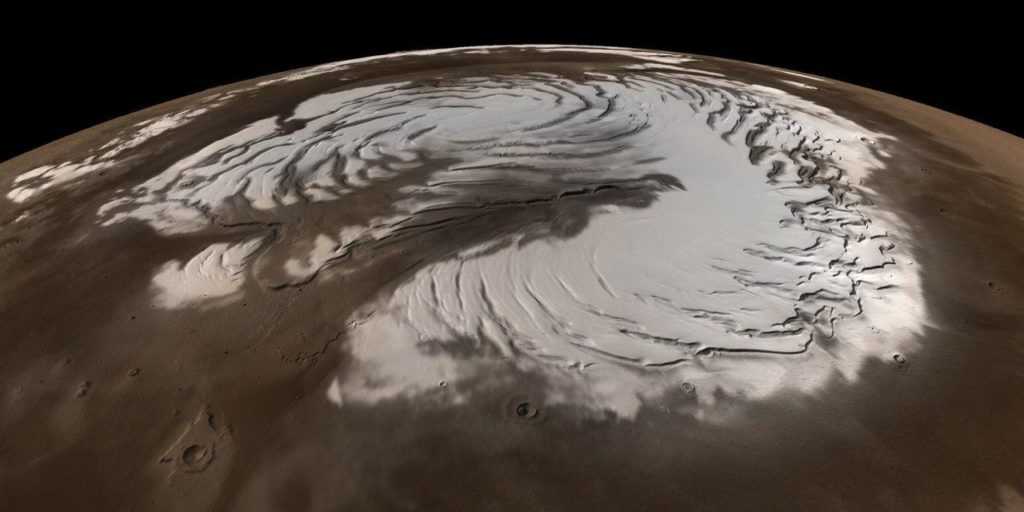

التعليقات :